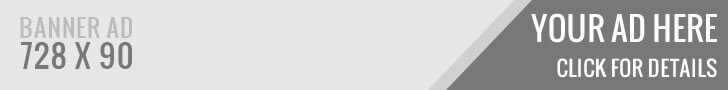الحيازة في القانون المدني: دراسة لأركانها وآثارها
الحـيازة في القـانـون المـدني:
دراسة لأركانها وآثارها
(بقلم الحقوقية: دعاء رشاد صوان)
من المنطقي أن الحيازة كانت الوسيلة الأولى التي عرفها الإنسان لاكتساب الملكية، إذ انسجمت مع تفكير الإنسان البدائي، فكان متى حاز شيئاً أصبح مالكاً له، ودافع عنه بكل ما امتلك من قوة. وبذلك شكّلت الحيازة في العصور القديمة الأساس الرئيسي لنشوء الملكية، لا سيما في الأحوال التي لم يكن فيها الشيء مملوكاً لأحد من قبل، سواء تعلّق الأمر بالأموال المنقولة أو العقارات، مهما بلغت بساطتها، كالكهوف مثلاً أو الأراضي غير المملوكة التي استخدمها للرعي أو للسكن.
ومن هنا تكمن أهمية الحيازة في طبيعتها المادية، المتمثلة في السيطرة الفعلية على شيء ما، سواء أكان عقاراً أم منقولاً، إذ تُعدّ أساساً لتحديد الحقوق والمسؤوليات القانونية المتعلقة بهذا الشيء. فهي تسهم في استقرار المجتمع، وتيسير انتقال الملكية، وحماية الحائز؛ فبدون الحيازة نواجه المنازعات والإشكالات حول ملكية المنقولات المادية والعقارات أيضاً، مما يؤدي إلى تعطيل سير المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء.
أولاً – مفهوم الحيازة
الحيازة لغةً تعني الجمعُ والضم، فيقال: حازَ المال حوزاً وحيازةً واحتازه احتيازاً أي قبضه وتملكه، بالتالي فإنّ كل من قبض شيئاً او استولى عليه يقال أنه قد حازه.
أمّا اصطلاحاً: الوضع المادي على الشيء قرينة على الملكية، وهو الغالب في التطبيق العملي ، إلّا أنّه لا يفيدُ بالملكية دائماً، كما في حالة الحائز العرضي (كالمستأجر)، الذي يضع يده على الشيء، ولكن لحساب الغير وليس لحساب نفسه.
وعرّفها المشرع أيضاً بأنها سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي، يظهر عليه بمظهر المالك أو صاحب حق يباشر عليه الأعمال التي يباشرها صاحب الحق.
كما تعرّف أيضاً بامتلاك شخص أو جهة لشيء مادي سواء كان عقاراً أو منقولاً مع إمكانية السيطرة عليه والاستفادة منه وقد تكون الحيازة مباشرة، كما في حال احتفاظ الشخص بمفتاح منزله وسكنه فيه، أو غير مباشرة كأن يؤجر المنزل لشخص آخر ويظل مالكاً له دون إشغال فعلي.
ثانياً – أنواع الحيازة
تقسم الحيازة من حيث طبيعة السيطرة إلى:
- الحيازة الكاملة (التامة): هي التي تشمل السيطرة الفعلية على الشيء وتشمل أيضاً نية التملك، كأن يكون الشخص مالكاً ظاهراً ويتصرف بالشيء كما لو كان له.
- الحيازة الناقصة (المؤقتة): هي حيازة الشخص للشيء بناءً على عقد أو اتفاق مع المالك، مثل المستأجر أو الوكيل أو الوديع، أي عنده سلطة على الشيء لكن لحساب شخص آخر.
- الحيازة المادية أو اليد العارضة: هي مجرد وضع اليد المؤقت والعابر على الشيء، بدون نية تملك ولا سند قانوني، مثل: من يحمل غرضاً لأحد أو يضع يده عليه لحظة دون سلطة قانونية.
ثالثاً – أركان الحيازة
1- الركن المادي:
تنص المادة 1084 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أن “الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو من خلال غيره على حق يجوز التعامل فيه”.
لكي نكون أمام حيازة صحيحة يجب أن يخضع الشيء محل الحيازة لسيطرة الحائز الفعلية، وذلك من خلال استحواذه المادي المباشر، أو عبر وسيط يقوم مقامه، وتظهر السيطرة الفعلية من خلال أعمال مادية تتم على الشيء، بشكلٍ يُظهره بمظهر المالك أو صاحب الحق العيني عليه، كأن يسكن الحائز في دار، أو يؤجرها، أو يزرع أرضاً، أو يقيم عليها أبنية، أما التصرفات القانونية البحتة، مثل: عقود البيع أو الإيجار، فلا تعد وحدها دليلاً كافياً على قيام الحيازة، لأنها لا تثبت بالضرورة السيطرة الفعلية على الشيء، إذ يمكن أن تصدر من شخص لا يملك الشيء ولا يحوزه أصلاً، كما في حالة من يبرم عقد بيع لعقار لا يملكه ولم يسبق له أن وضع يده عليه.
ويُشترط في الأعمال المادية التي يباشرها الحائز أن تكون متكررة أو ذات أهمية ودلالة كافية، بحيث تُظهر بشكل لا لبس فيه أن الحائز يتصرّف تصرف المالك أو صاحب الحق، لا مجرد مستخدم عابر ويجوز للحائز أن يباشر تلك الأعمال بنفسه، أو من خلال الغير ممن يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، كالخدم، أو العمال، أو المستخدمين، أو حتى الوكيل الذي يتصرّف ضمن حدود وكالته، غير أن هذا الحكم يقتصر على العنصر المادي للحيازة، ولا يُغني عن ضرورة توافر العنصر المعنوي كذلك يجوز أن تثبت الحيازة لمن كان ناقص الأهلية، كالطفل غير المميز، وذلك من خلال مباشرة أعمال السيطرة المادية بواسطة من ينوب عنه قانوناً، كما جاء في المادة 1084/2 من مشروع القانون المدني الفلسطيني، والتي تنص على أن “غير المميز يكتسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية”.
وتجوز كذلك الحيازة عن طريق الاستخلاف، أي عندما تنتقل السيطرة المادية من شخص كان يحوز الشيء إلى شخص آخر، كما في حالة قيام البائع بتسليم المبيع للمشتري، فتصبح السيطرة الفعلية من نصيب المشتري ولو لم يضع يده عليه مباشرة، ويكفي في هذه الحالة تمكينه من السيطرة، مثل تسليمه مفاتيح العقار أو مستندات الملكية، أو تمكينه من الدخول إلى العقار.
وأخيراً، قد تتحقق الحيازة المشتركة أو الحيازة على الشيوع، حيث يتوافر العنصر المادي من خلال مباشرة السيطرة بالاشتراك مع الغير، بينما يكون العنصر المعنوي مفقوداً أو غير متحقق بشكل مستقل. ومثال ذلك أن يسكن شخصان معاً في عقار دون أن يقوم أحدهما بأعمال تدل بشكل منفرد على نية التملك أو الاستئثار بالحيازة.
2- الركن المعنوي:
لكي تنعقد الحيازة بشكل صحيح وتُنتج آثارها القانونية، لا يكفي توافر العنصر المادي المتمثّل في السيطرة الفعلية على الشيء، بل لا بد أيضاً من تحقق العنصر المعنوي، والذي يتمثل في نية الحائز في استعمال الشيء كمالك أو صاحب حق، أو الظهور أمام الغير بهذا المظهر.
وبما أن هذا العنصر قائم على الإرادة والتمييز، فإنه يفترض توافر الأهلية القانونية لدى الحائز، فلا يمكن أن تنشأ الحيازة القانونية لصالح شخص عديم التمييز – كالصغير غير المميز أو المجنون – إذا باشر الحيازة بنفسه، وذلك لانعدام القدرة على تكوين نية التملك الواعية، ومن ثم غياب العنصر المعنوي، ومع ذلك يمكن أن تتحقق الحيازة لصالح عديم التمييز عن طريق من ينوب عنه قانوناً، كوليّه أو وصيه أو القيم عليه.
ومن المهم التنبيه إلى أن الأعمال المبنية على العفو أو التسامح لا تُنشئ حيازة قانونية، لأنها تفتقر إلى العنصر المعنوي، فمثلاً إذا سمح شخص لجاره بالمرور في أرضه أو بفتح نافذة على حديقته على سبيل التسامح، فإن هذا لا يُرتب لجاره حق ارتفاق، لانتفاء نية التملك أو الظهور بمظهر صاحب الحق.
ووفقاً للقاعدة العامة، فإن توافر العنصر المادي للحيازة يُعد قرينة على توافر العنصر المعنوي، فلا يُلزم الحائز بإثبات أنه يحوز لحسابه الخاص، بل يُفترض ذلك قانوناً ، ومع ذلك فإن هذه قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ويجوز للغير أن يثبت أن الحائز إنما يحوز الشيء لحساب شخص آخر أو بإذنه، وفي هذه الحالة تنتفي الحيازة القانونية لغياب نية التملك، ومن الأمثلة على ذلك: إذا استأجر شخص عقاراً وبدأ في استعمال قطعة أرض مجاورة دون علم المؤجر، ومارس عليها أعمالاً مادية، فإن تلك الحيازة لا تُعد قانونية لصالح المؤجر، ولا تُنشئ له حقاً، لأن الحائز (المستأجر) لا يحوزها نيابة عن المؤجر، ولا بصفته نائباً قانونياً له.
رابعاً – آثار الحيازة
الحيازة وفقاً للمجلة والأحكام القضائية الفلسطينية هي وضع اليد المادي والمعنوي على شيء معيّن، بقصد التصرّف فيه كمالك، وتتكوّن من ركنين أساسيين: ركن مادي يتمثل في السيطرة الفعلية على الشيء، وركن معنوي يتمثل في نية التملك. وإذا ما توافرت شروط معينة واستمرّت الحيازة لفترة قانونية معيّنة، فإنها تؤدي إلى آثار قانونية هامة أبرزها اكتساب الحق، سواء كان حق ملكية أو غيره من الحقوق العينية.
من أبرز الآثار القانونية للحيازة في النظام الفلسطيني، كما ورد في المادة 957 من مجلة الأحكام العدلية، أن الحيازة لا تنقطع إلا إذا استمرّ المانع المؤقت من السيطرة لمدة سنة كاملة، وهذا يعكس مبدأ استمرارية الحيازة كمصدر للحماية القانونية. كما توضّح المادة 958 أن من فقد حيازته بالقوة يحق له رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ الفقدان، مما يدل على أن المشرّع يعطي أولوية لحماية الحائز حتى لو لم يكن مالكاً، طالما كانت حيازته هادئة وعلنية.
ويُعتبر أهم الأثر المترتب على الحيازة المستوفية للشروط هو اكتساب الملكية بالتقادم، كما هو منصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني المصري، والتي يمكن الاستئناس بها لفهم التوجّه الفقهي الفلسطيني. فوفقاً لهذه المادة، يكتسب الحائز حقاً عينياً على الشيء بعد مرور مدة معينة دون اعتراض من صاحب الحق الأصلي، شريطة أن تكون الحيازة سلمية، علنية، مستمرة، وبنية التملك.
إن المدة المحددة لاكتساب الملكية بالتقادم تختلف باختلاف نوع المال محل الحيازة؛ فعادة ما تكون 15 سنة للعقارات، و5 سنوات للمنقولات. وهذه المدة لا تبدأ إذا كانت الحيازة مشوبة بالعنف أو كانت مجرد استعارة أو وكالة أو إيجار، مما يؤكد أن النية الجدية للتملك عنصر حاسم في ترتيب الآثار القانونية.
من الآثار الهامة الأخرى للحيازة أيضا:
- حماية الحائز: الحائز الذي يسيطر على الشيء بشكل هادئ وعلني لمدة معينة، يتمتع بحماية قانونية تحول دون إزاحته دون حكم قضائي.
- استقرار المعاملات: فمرور الوقت مع حيازة مستقرة يضفي على العلاقة القانونية طابعاً من القطعية، ويمنع الرجوع إلى منازعات تاريخية قديمة.
- اكتساب الحقوق العينية الأخرى: لا تقتصر آثار الحيازة على اكتساب الملكية فقط، بل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى اكتساب حقوق مثل الانتفاع أو الاستعمال، إذا توافرت شروط التقادم المكسب.
تطبيقات الحيازة كثيرة في الواقع العملي، وتُعدّ من أبرز وسائل إثبات الملكية، خاصة في المناطق التي لم تُنظّم فيها سجلات الطابو بصورة دقيقة. فمثلاً، من يحوز أرضاً زراعية لخمسة عشر عاماً، ويقوم بزراعتها علناً، دون منازعة من أحد، يمكنه قانوناً المطالبة بتثبيت ملكيته استناداً إلى مبدأ التقادم.
وفي النهاية، تُعتبر الحيازة في القانون الفلسطيني أداة فعّالة لكسب الحقوق وحمايتها، وهي تقوم على مبدأ بسيط وعادل: “الحق لا يُهمل، ولكن لا يُنتظر إلى الأبد”. لذلك، فإن من يترك ملكه دون استعمال أو اعتراض لسنوات طويلة، يفقد حمايته، بينما يتمكّن الحائز الجاد من تحويل الحيازة إلى ملكية محمية قانوناً.
خامساً – الخاتمة:
تناول هذا المقال مفهوم الحيازة التي تشكل وسيلة لاكتساب الحقوق العينية وأهمها الملكية وذلك عند توافر شروطها القانونية وتوافر عنصريها المادي والمعنوي اذ تساهم الحيازة في حماية الحائز وتقليل النزاعات واستقرار المعاملات خاصة في غياب التوثيق الرسمي أو تعقيد إجراءات التسجيل. بالتالي فإن الحيازة ليست فقط سيطرة مادية وانما حلاً قانونياً وعادلاً لكل من مارس حقه مستوفياً شروطها وبنية تملك صادقة.
بقلم الحقوقية: دعاء رشاد صوان
مواضيع أخرى ذات علاقة: