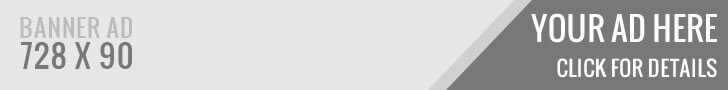اللجوء بوصفه مقاومة: كيف يهدد اللاجئ النظام العالمي؟
اللجـوء بوصفـه مقاومـة:
كيـف يهـدد اللاجئ النظـام العـالمـي؟
(بقلم الباحثة : آلاء تيسير طيبي)
لطالما قُدّم اللاجئ في الخطاب القانوني والإنساني بوصفه الضحية النموذجية: إنسان مُستنزف، مخلوع من المكان، محطم الهوية، ينتظر الخلاص من دولة أو منظمة. هذه الصورة، رغم نواياها الإنسانية، تحولت إلى إطار ناعم للإخضاع، حيث يُختزل اللاجئ إلى “كائن إغاثة ” فاقد للقرار السياسي، تُمارس عليه أشكال الرعاية المؤسسية تحت شعارات الحماية والمساعدة.
لكن ماذا لو كانت هذه الصورة نفسها هي امتداد للمنظومة التي أنتجت اللجوء اصلاً ؟ وماذا لو أن وجود اللاجئ، كواقع وجسد ورغبة في العودة، هو فعل مقاومة بحد ذاته؟
اللاجئ – كما سنجادل – ليس ضحية صامتة بل شاهد خطير، يُهدد سرديات السيادة، ويكسر حدود الدول، ويفضح تناقضات القانون الدولي. فاللجوء ليس فقط نتيجة حروب، بل ايضاً رفض للنظام الذي يجعل من التشريد سياسة، ومن الاقصاء قانوناً. في هذا المقال يتم تفكيك الرائج عن أن اللاجئ مجرد من الفعل، ولتوضيح أن فعل اللجوء فعل سياسي مقاوم، يتحدى الأنظمة، ويزرع فيها الارتباك.
أولاً – جذور المفهوم من “الضحية ” إلى “الفاعل السياسي”
منذ اعتماد اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951، تم تأطير اللاجئ في القوانين الدولية “شخص يستحق الحماية بسبب الاضطهاد”، وهي حماية مشروطة بالضعف والانفصال عن أي نشاط سياسي. هذا التأطير رغم ضرورته في وقتٍ ما، أسس لمنظور قانوني يفرغ اللاجئ من قدرته على التأثير، ويضعه دوماً في موقع التابع لا الفاعل.
بمرور العقود، ومع تصاعد أزمات اللجوء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، بدأت تتضح حدود هذا النموذج القانوني: فالقانون الدولي لا يعترف باللاجئ إلا اذا كان هارباً من خطر، لكنه لا يراه إن اختار البقاء في المخيم مقاوماً، أو رفض الاندماج كوسيلة لصون هويته. وبلغة أخرى يكافئ اللاجئ حين يصمت، ويعاقب حين يعترض.
هذا المنطق يعيد إنتاج نفس البنية التي تسببت في تهجيره:
- السلطة التي تقرر من هو “اللاجئ الشرعي”.
- والدولة التي تملك حق تحديد إن كان يستحق البقاء.
- والمنظمات تحوله الى رقم في تقارير التمويل.
لكن في قلب هذه المعادلة المختلة، يظهر اللاجئ الفلسطيني بوصفه استثناءً متمرداً: فهو لا يهرب من الذاكرة، ولا يرضى بالتعريف الضيق للنجاة. حق العودة بالنسبة له ليس مجرد حلم، بل بيان سياسي مفتوح، يتحدى أنظمة القانون والسياسة والهوية معاً. إن تمسك اللاجئ الفلسطيني – لعقود- بخيامه المؤقتة، ورفضه الاستيعاب الكامل، وتحويل المخيمات إلى فضاءات اجتماعية نابضة، هو بمثابة رفض عميق لمنطق الإلغاء والدمج القسري. وهنا يصبح واضحاً أن اللاجئ ليس فقط محض أثر للحرب، بل يمكن أن يكون فاعلاً في معركتها المستمرة.
ثانياُ – اللاجئ ككسر للحدود والنظام الدولي
في المنظومة الدولية الحديثة، تمثل “الدولة” الوحدة الأساسية للهوية القانونية، السياسية، والوجودية. فالفرد يُعرف بجنسيته، يُحمى بجواز سفره، ويحاسب بناءً على موقعه داخل خارطة الدول. لكن اللاجئ – بحكم خروجه من هذه المعادلة – يفضح الأساس الزائف للنظام العالمي. فاللاجئ ببساطة، لا ينتمي الى أي مكان، وهنا تحديداً يكمن التهديد. فهو:
- لا يدرج ضمن خرائط الأمم.
- لا تحكمه سيادة وطنية.
- لا يملك صوتاً انتخابياً أو تمثيلاً سياسياً.
ومع ذلك فهو موجود – بكل ثقله الجسدي، والرمزي، والسياسي. وجوده يكسر الوهم القائل بأن “السيادة الوطنية” قادرة على إحتواء الجميع، وأن القانون الدولي شامل وعادل.
عندما يقف اللاجئ على الحدود، لا يطرق باب الدولة فحسب بل يربك بنيتها بالكامل وهنا تكمن الأسئلة:
- من يحق له الدخول؟
- من يُعرف “الوطن”؟
- وهل الانتماء مسألة قانونية أم وجدانية؟
بهذا المعنى، اللاجئ هو نقطة إختراق داخل النظام. جسده في الخارج، لكن قضيته في الداخل. وهو “خارج الحدود” و “داخل النزاع” في آن واحد معاً. حتى المخيم – بوصفه مساحة مؤقتة – يتحول إلى خطر دائم.
ليس فقط لأنه يذكّر بالعجز الدولي عن حل الصراع، بل لأنه يرفض الاندماج والذوبان، ويتمسك بذاكرة الأرض أكثر من الدولة المضيفة نفسها. فاللاجئ بذلك، لا يطلب فقط مأوى. هو يطالب – ولو بصمته – بإعادة صياغة خريطة العدالة، والاعتراف، والحق.
ثالثاً – اللجوء كأداة مقاومة رمزية ومادية
حين يُحرم الانسان من الوطن، لا يتبقى له سوى جسده كمساحة وحيدة للمقاومة. لكن ماذا يحدث حين يتحول هذا الجسد، المخلوع من الخريطة، إلى علامة سياسية عصية على المحو؟ اللجوء في حد ذاته ليس خضوعاً للواقع، بل رفض صامت له. فاللاجئ لا يطالب فقط بمكان يأويه، بل يفضح – بمجرد وجوده – أن الوطن ليس مجرد إحداثيات، وأن الطرد لا يلغي الحق.
في المخيم، حيث يفترض أن تدفن الهوية، تنبت الذاكرة وتتكثف. كل خيمة هي بيان سياسي، كل مفتاح معلق على الحائط هو وثيقة رفض، وكل طفل يولد بلا جنسية هو تذكير بأن القضية لم تنته، بل تكاثرت. حين يرفض اللاجئ العودة المشروطة، وحين يُصر على هويته الأصلية رغم كل محاولات الدمج والتذويب، فهو يمارس شكلاً راقياً من المقاومة الرمزية.
المقاومة هنا لا تتجلى بالبندقية، بل بالصبر، بالبقاء ، وبالذاكرة الجمعية. والمخيم يصبح ثكنة ناعمة للمواجهة، واللاجئ يتحول من “رقم” في وثيقة اللجوء إلى خلل بنيوي في هندسة النظام الدولي. أما على المستوى المادي، فتمسك اللاجئين في حق العودة –لا كمطلب قانوني فحسب، بل كإرادة جماعية – هو تحد مباشر للنظام العالمي الذي يحاول هندسة الوعي الجمعي على نسيان النكبة أو “تجاوزها”.
اللاجئ ليس عبئاً إنسانياً، بل كياناً مخيفاً، لا يقبل أن يختزل في معونة أو بطاقة تموين، بل يصر أن يكون شاهداً حياً على جريمة لم تغلق ملفاتها.
رابعاً – ردّ الفعل العالمي “قمع، إقصاء، تطبيع”
حين يعجز النظام العالمي عن إخماد صوت، يبدأ بمحاولات تدجينه. وهكذا كان تعامله مع قضية اللاجئين: لا بإيجاد حل جذري، بل بإنتاج آليات ناعمة لإسكات المعنى الثوري لوجود اللاجئ، وتتجلى هذه الاليات في ثلاثة مستويات مترابطة:
1- القمع الأمني (حين يتحول اللاجئ إلى تهديد أمني):
في دول، لم يعد يُنظر إلى اللاجئين كضحايا بل كخطر. “المخيم يُطوّق، اللاجئ يُراقَب، والتنقل يُقيّد” وفي دول أخرى يمنع اللاجئ حتى من التعليم أو العمل، ليظل رهينة الحاجة، وقابلاً للتطويع.
2- الإقصاء السياسي (حين يستبعد اللاجئ من مستقبل قضيته):
تُدار ملفات اللاجئين غالباً دون تمثيل فعلي لهم، وترسم الحلول بمعزل عنه، وتفرض عليه “خيار العودة الرمزية” أو “التوطين” أو “الاندماج القصري”، في كل محاولة لمسح أثره من الذاكرة السياسية. لكن المشكلة أن اللاجئ لا يختفي، وجوده تذكير بفشل كل تلك الحلول.
3- التطبيع الإغاثي (حين تختزل المأساة في كرتونة مساعدات):
الأخطر من القمع والاقصاء، هو التطبيع مع اللجوء نفسه، أن يتحول اللجوء إلى حالة دائمة، أن تصبح المخيمات مدناً خفية تُدار كجزر معزولة، وأن تتحول المعاناة الى نظام. وان المنظمات الدولية، رغم دورها الإنساني، غالباً ما تساهم في هذا التطبيع، حين تختزل وجود اللاجئ في إحصائيات، وخيام، وتقارير تمويل، دون مساءلة حقيقية عن لماذا لا يزال اللاجئ لاجئاً؟ ومن المستفيد من بقائه في هذه الحالة؟
في المحصلة، يشبه تعامل النظام العالمي مع اللاجئين عملية إخماد سياسي ناعم، تمارس تحت قناع الإغاثة، وحقوق الانسان، والسيادة الوطنية.
خامساً – من اللجوء إلى التحرر
إن اللاجئ في النظرية التقليدية، هو حالة مؤقتة يجب تصحيحها. لكن ماذا لو لم يكن الامر كذلك؟ ماذا لو كان اللاجئ هو كاشف أعطاب العالم وليس مجرد خلل عرضي فيه؟
فالتحرر في هذا السياق لا يعني فقط وقف الاضطهاد أو العودة المادية للأرض، بل يسلزم مراجعة جذرية لبنية النظام الدولي الذي ينتج اللجوء، وتحميل الدول والجهات الفاعلة مسؤولياتها القانونية والسياسية تجاه الأسباب الجذرية للنزوح، سواء أكانت حروباً مفروضة، أو اختلالات اقتصادية دولية، إن الخروج من حالة “اللجوء” الى حالة “التحرر”، يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الانسان والدولة، وبين الحقوق والسيادة، بحيث لا تكون حماية اللاجئ استثناءً من القاعدة، بل امتداداً طبيعياً لمبدأ الكرامة الإنسانية في القانون الدولي المعاصر.
سادساً – الخاتمة
أمام تزايد اعداد اللاجئين عالمياً، بات من الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونية الدولية الحاكمة لقضايا اللجوء، والتي ما زالت تعتمد على أطر وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، وتدار بمنطق الدولة لا بمنطق الحق. لقد أثبتت العقود الأخيرة أن الحلول المبنية على الإغاثة والمعونات قصيرة الأمد غير كافية، بل ترسخ حالة الضعف والتبعية. وأن التحرر من اللجوء لا يقاس بالعودة فقط، بل بمدى قدرة القانون الدولي على مساءلة الفاعلين، وردم الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق السياسي. وحدها العدالة الهيكيلة، التي تتعامل مع جذور اللجوء، قادرة على تحويل ملف اللاجئين من عبء على النظام الدولي إلى اختبار حقيقي لمصداقيته وشرعيته.
بقلم الباحثة: آلاء تيسير طيبي
مواضيع أخرى ذات علاقة:
- الهرمية التشريعية وموقع المعاهدات منها.
- ورقة بحثية: ما مدى التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بواجبها الأخلاقي والقانوني اتجاه اللاجئ الفلسطيني؟.
- إجراءات تعديل المعاهدات الدولية وتصحيحها.
- حقوق الإنسان بين التطبيق والعدم.
- حق الإنسان في الحياة.
- ما الفئة القانونية التي ينتمي لها القانون الدولي إنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان وما السبب؟.