نساء فلسطين في مواجهة الفقر والاحتلال: التمكين الاقتصادي كمفصل للتحرر
نسـاء فلسطيـن في مواجهـة الفقـر والاحتلال: التمكيـن الاقتصـادي كمفصـل للتحـرر
(بقلم الباحثة: ماسة رائد عورتاني)
في فلسطين، لا يُقاس الاستقلال الاقتصادي للمرأة بعدد النساء العاملات فحسب، بل بمدى قدرتهن على الوصول إلى موارد اقتصادية مستدامة تحميهن من التقلبات السياسية والاجتماعية. فالمرأة التي تعتمد اقتصاديًا على الأسرة أو الزوج او على قطاع هش مثل العمل غير الرسمي، لا تمتلك حرية اتخاذ قرارات مصيرية بشأن حياتها، بدءًا من خيارات العمل والتعليم، وصولًا إلى الاستقلال الشخصي بعيدًا عن الضغوط المجتمعية.
لكن المشكلة تتجاوز حدود التقاليد أو غياب سياسات داعمة؛ فهي بنية متكاملة من المعيقات القانونية والاجتماعية التي تجعل عمل المرأة امتيازًا هشًا، لا حقًا مكفولًا. ففي ظل القوانين التي لا توفر حماية كافية، وتوزيع الأدوار الجندرية الذي يربط المرأة بوظائف محددة، تجد النساء أنفسهن أول من يتم الاستغناء عنهن في الأزمات الاقتصادية. ومع اندلاع الحروب، يصبح هذا الواقع أكثر وحشية، حيث تتسع الفجوة الاقتصادية بين الرجال والنساء، وتُدفع النساء نحو أدوار غير رسمية وغير محمية اقتصاديًا، ما يرسّخ تبعيتهن بدلًا من تعزيز استقلاليتهن.
هذا المقال لا يتناول فقط العوائق التي تواجه استقلال المرأة اقتصاديًا، بل يدرس كيف تتضاعف هذه العوائق في وقت الحرب، وكيف أن غياب نظام حماية اجتماعية فعّال يجعل النساء أكثر هشاشة، ويجعل الاستقلال الاقتصادي لهن أشبه بمعركة لا تنتهي.
أولاً – العوائق الاجتماعية
الفجوة الكبيرة بين الجنسين في القوى العاملة الفلسطينية تُعد مؤشرًا واضحًا على التحديات التي تواجهها النساء في المجتمع الفلسطيني. ففي عام 2021، أظهرت البيانات أن 17.2% فقط من النساء فوق 15 عامًا يشاركن في القوى العاملة مقارنة بـ 68.9% من الرجال على الرغم من ان النساء تشكل نسبة اكبر من خريجي جامعات الضفة الغربية. هذه الفجوة لا تعكس فقط التحديات الاقتصادية، بل أيضًا القيم الاجتماعية الراسخة التي تحد من فرص النساء وتثبط طموحاتهن[1]Palestine central bureau of statistics https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=5733.
غالبًا ما تكون المعايير المجتمعية الراسخة هي العائق الأول أمام الاستقلال الاقتصادي للمرأة. الأدوار التقليدية التي تُحدد للمرأة – حيث يتم تفضيل الأعمال المنزلية على حساب المسار المهني – لا تقتصر على تثبيط النساء عن تحقيق طموحاتهن فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى غياب هذه الطموحات تمامًا من الاساس لصالح الحياة الزوجية. في العديد من الحالات، يُحرم العمل من النساء منذ البداية، مما يضعهن في حالة تبعية اقتصادية كاملة لزوجهن، الأمر الذي يحدّ من قدرتهن على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن حياتهن ومستقبلهن. هذه القيود، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، تساهم بشكل كبير في توسيع الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة الفلسطينية وتفاقم من وضع النساء في سوق العمل وبالتالي بحياتها.
هذه القيود لا تختلف كثيرًا عن واقع الفلسطينيين عمومًا في ظل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تفرض التبعية الاقتصادية لإسرائيل قيودًا على خياراتنا حتى دون وعي مباشر. وبالنسبة للمرأة، فإن هذه التبعية لا تقتصر على الحدّ من حريتها فحسب، بل قد تتركها في وضع اقتصادي كارثي في حال حدوث الانفصال، إذ تجد نفسها مضطرة إلى خوض معارك قانونية معقدة للحصول على الحد الأدنى من النفقة او اي شكل من الدعم المالي، بعد أن قضت سنوات دون عمل أو استقلال مالي. بل إن الأمر قد يكون أكثر قسوة في حالات وفاة الزوج، حيث تكتشف المرأة فجأة أن غياب أي مورد مالي مستقل يعني انعدام شبكات الأمان، وتركها في مواجهة واقع اقتصادي لا يرحم، بلا أي حماية تضمن لها الحد الأدنى من العيش الكريم.
شريحة أخرى من النساء الفلسطينيات هن اللواتي يعملن في القطاعات التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها “مناسبة” للمرأة، مثل قطاع التعليم. ورغم أن هذه المهن تُعد من الركائز الأساسية في المجتمع، إلا أن المشكلة تكمن في كونها المسار الأكثر توفرًا للنساء بسبب القوالب النمطية، مما يحدّ من فرصهن في خوض مجالات مهنية أخرى تتيح لهن تحقيق نمو اقتصادي ومهني حقيقي. هذا التصنيف المسبق للأدوار المهنية لا يفرض قيودًا على اختيارات النساء فحسب، بل يُكرّس واقعًا تكون فيه الطموحات محدودة ضمن إطار ما يراه المجتمع “ملائمًا” لهن، بدلًا من السماح لهن بالمنافسة في مختلف القطاعات على أساس الكفاءة والاستحقاق.
إلى جانب ذلك، فإن العاملات في هذه القطاعات لا ينعمن بالضرورة بالاستقلال المالي، حيث لا تزال هناك حالات تُحرم فيها النساء من التحكم بأجورهن، إما بسبب الأعراف الاجتماعية أو لأن رواتبهن تُحوّل مباشرة إلى حسابات أزواجهن المصرفية، ما يُبقيهن في دائرة التبعية الاقتصادية حتى وهنّ يعملن.
ووفقًا لدراسة أجراها مركز الدراسات والوثائق النسائية الفلسطينية: “يوافق ربع الفلسطينيين على أن المرأة يجب أن تبقى في المنزل، وترعى الأطفال، وتدير شؤون منزل زوجها، ولا تذهب إلى العمل تحت أي ظرف من الظروف. ويعتقد 40% أن المرأة العاملة لا تربي أطفالها بشكل جيد بسبب انشغالها بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 77% أن المرأة العاملة أكثر عصبية من المرأة غير العاملة، ويعتقد 43% أن المرأة العاملة تسيطر على زوجها مقارنة بالمرأة غير العاملة (مما يعد اقرارا بان التمكين الاقتصادي قد يستخدم كاداة تحكم بالفرد والمجتمع) … علاوة على ذلك، يوافق أكثر من 10% على أنه ينبغي على أصحاب العمل فصل النساء الحوامل من وظائفهن. ويعتقد أكثر من نصف المشاركين أنه لا فائدة من عمل امرأة لديها أطفال دون سن الخامسة.”
يتم توضيح كون المرأة عاملة وأمًاً في الوقت نفسه يضيف المزيد من التحديات إلى القائمة التي تواجهها النساء. غالبًا ما تضع التوقعات الثقافية المسؤولية الرئيسية لرعاية الأطفال على عاتق الأمهات، مما قد يتعارض مع توقعات أن يكون العاملون مكرسين بالكامل لوظائفهم دون تشتيت بسبب الأسرة. هذا التصادم بين صورة “الأم المثالية” و”العامل المثالي” يمكن أن يؤدي إلى التمييز ضد الأمهات العاملات[2]Ishizuka, P. (2021). The motherhood penalty in context: Assessing discrimination in a polarized labor market. Demography, 58(4), 1275–1300. https://doi.org/10.1215/00703370-9373587. وحتى قبل التعامل مع تحديات الموازنة بين العمل والأسرة، تواجه الأمهات العاملات عقبة كبيرة: الحصول على وظيفة في المقام الأول. يمكن أن يجعل “جدار التحيز الأمومي” أو “عقوبة الأمومة” (Maternal Wall or Mommy Penalty) الأمهات العاملات مرشحات أقل جاذبية في نظر بعض أصحاب العمل، وغالبًا ما يتم تحفيز هذا التحيز عندما ترغب الأم في أخذ إجازة أمومة. يمكن أن تؤدي المخاوف بشأن احتياجات رعاية الأطفال، أو النزاعات المحتملة في الجدول الزمني، أو الانخفاض المتصور في الالتزام إلى تخطي الأمهات العاملات عند منح الفرص، على الرغم من مؤهلاتهن. وهذا يضيف طبقة أخرى من التوتر وعدم الأمان إلى بحثهن عن عمل، مما يجعل من الصعب العثور على وظيفة تسمح لهن بمساهمة مهاراتهن ودعم أسرهن. وإذا تم توظيفهن في النهاية، فإنهن يواجهن ضغطًا مجتمعيًا هائلًا للتفوق في كل من العمل والحياة الأسرية.
المرأة العاملة، خاصة الأمهات، تتحمل عبئًا مزدوجًا من العمل داخل المنزل وخارجه، مما يسبب لها إرهاقًا جسديًا ونفسيًا كبيرًا وقد يقلل من كفاءة أدائها فعليا في كلا المجالين. المشكلة تكمن في كيفية تعامل المجتمع وأرباب العمل مع هذه الواقعة. فبدلاً من تقديم حلول وآليات تدعم المرأة في أداء دورها، مثل إشراك الزوج بشكل أكبر في المسؤوليات المنزلية، يُلاحظ تجاهل توظيف المرأة، خاصة الأمهات العاملات، في العديد من الحالات. وبالرغم من أن مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية قد تُحسن الوضع إلى حد ما، إلا أن ذلك لا يعد كافيًا لدعم المرأة في تحقيق طموحاتها المهنية والاقتصادية. لذا يجب النظر في الوضع القانوني وتقييم فعاليته في توفير الدعم الفعلي لتشغيل المرأة وتعزيز مكانتها في سوق العمل.
ثانياً – العوائق القانونية
1- قانون العمل
أولًا، لا تزال وزارة العمل الفلسطينية غير قادرة على تنفيذ جزء كبير من أحكام قانون العمل لعام 2000 بسبب قلة الميزانيات المخصصة لها، بالإضافة إلى نقص عدد المفتشين لذلك يركزون غالبًا على مراقبة المنشآت الخطرة التي يعمل بها الرجال، بينما يتم إهمال المنشآت الأخرى وضعف الرقابة على مسألة المساواة في الأجور بين الموظفين والموظفات .ثانيًا، يعيق غياب تفويض قانوني محدد يمنح مفتشي العمل صلاحيات فرض المساواة بين الجنسين قدرتهم على ضمان تطبيق هذه المبادئ، إلى جانب غياب العقوبات المحددة في لوائح العمل يؤدي إلى استمرار بعض أصحاب العمل في التمييز بين الموظفين في الوظائف المماثلة[3]Salameh, N., Dawas, R., & Qarawi, Z. (2024). Legal Constraints to Protect Working Women: A comparative study under international labor standards and the Palestinian Labor Law. Maǧallaẗ … Continue reading.بناء على ذلك، قد يستغل بعض أصحاب العمل هذا الفراغ القانوني من خلال استهداف النساء من الطبقات الدنيا بأجور أقل أو بظروف عمل أسوأ، بافتراض أنهن أقل قدرة على المطالبة بحقوقهن. وهذا يعزز مشكلة الحقوق المالية غير الملباة وانعدام الأمان الاقتصادي للنساء، حتى عندما يتمكنّ من الحصول على وظيفة.
وعلى الرغم من أن قانون العمل لعام 2000 يتضمن المادة 100 التي تحظر التمييز بعد توقيع العقد، إلا أنه لا توجد أي مواد في قانون العمل الفلسطيني أو القانون الأساسي الفلسطيني تعالج بشكل محدد التمييز أثناء عملية التوظيف نفسها (حطاب، 2016). هذا الفراغ القانوني يسمح لأصحاب العمل بممارسة التمييز ضد النساء خلال المرحلة الحاسمة للتوظيف.
أما فيما يتعلق بالقضية الكبرى المتمثلة في التحرش الجنسي، فهناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات على قانون العمل الفلسطيني لحظر العنف والتحرش في أماكن العمل بشكل صريح، وتحديدهما بوضوح، وإنشاء نظام شكاوى، وفرض عقوبات رادعة على المنتهكين[4]المرجع السابق وإلى أن يتم تحقيق ذلك، سيظل التهديد المستمر بالتحرش الجنسي عائقًا كبيرًا أمام النساء الفلسطينيات الباحثات عن عمل. فالخوف من التعرض للتحرش أثناء التنقل أو في مكان العمل نفسه يخلق أثرًا مثبطًا، مما يدفع العديد من النساء إلى الحد من حركتهن، إما بالبقاء في وظائف قريبة من المنزل أو بالانسحاب تمامًا من سوق العمل. ولا يؤدي ذلك فقط إلى كبح فرصهن الاقتصادية ونموهن الشخصي، بل يعزز أيضًا القيود المجتمعية المفروضة عليهن.
علاوة على ذلك، لا يمنح أصحاب العمل العاملات أي حقوق تتجاوز ما هو منصوص عليه صراحة في قانون العمل. لذلك، يجب أن ينص قانون العمل بوضوح وحزم على أحكام تضمن امتثال أصحاب العمل للوائح المتعلقة بالعاملات. وعلى الرغم من أن المادة 102 من قانون العمل الفلسطيني تهدف إلى حماية النساء الحوامل والمرضعات من خلال النص على أن “يجب على المنشأة توفير تسهيلات تتناسب مع احتياجات النساء العاملات”، إلا أن هذه المادة تعاني من ضعف جوهري: فهي لا تحدد ماهية هذه التسهيلات. هذا الغموض يترك مسؤولية تحديد المرافق الأساسية مثل دورات المياه، ومساحات الرضاعة، أو الكراسي الخاصة بالحوامل بالكامل لأصحاب العمل الأفراد، مما يسهل عليهم التهرب من مسؤولياتهم تجاه موظفاتهم، ويترك النساء العاملات في وضع ضعيف يعوق قدرتهن على فرض حقوقهن. ومن الناحية المثالية، كان يجب على وزارة العمل أو مجلس الوزراء إصدار قرار يحدد هذه التسهيلات بوضوح، لضمان وضع معايير موحدة لهذه المرافق[5]المرجع السابق.
2- قانون الضمان الاجتماعي
يهدف الضمان الاجتماعي، بحكم دوره، إلى ضمان الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمان الاقتصادي للمواطنين. وعلى الرغم من أن عدد النساء اللواتي يحصلن على الحماية الاجتماعية أقل من الرجال، ومعظم الأطفال غير مشمولين أيضًا (منظمة العمل الدولية، 2021)، فإن الدراسات تظهر أن هذه البرامج تحقق تأثيرًا إيجابيًا أكبر على النساء والفتيات. ويكون هذا التأثير قويًا بشكل خاص في المناطق الفقيرة جدًا ولصالح الفئات الأكثر ضعفًا، مثل اللواتي يعشن في مناطق منخفضة الدخل، أو ذوات التعليم المحدود، أو اللواتي يتحملن أعباء منزلية ثقيلة[6]Perera, C., Bakrania, S., Ipince, A., Nesbitt‐Ahmed, Z., Obasola, O., Richardson, D., Van De Scheur, J., & Yu, R. (2022). Impact of social protection on gender equality in low‐ and … Continue reading، وهو ما ينطبق على معظم النساء الفلسطينيات، مما يستدعي تحليل التقاطع بين قوانين العمل وقوانين الضمان الاجتماعي من منظور جندري.
في سياق الحقوق المالية للنساء في سوق العمل، يمكن تمكين الضمان الاجتماعي للعب دور أكثر فاعلية. ويتمثل أحد الحلول في تنفيذ نظام للغرامات والعقوبات، حيث يواجه أصحاب العمل الذين يثبت انتهاكهم لقوانين العمل المتعلقة بالمساواة في الأجور، أو إجازة الأمومة، أو غيرها من الحقوق المالية، عواقب مباشرة من قبل نظام الضمان الاجتماعي. ويمكن أن تكون هذه العقوبات مالية، حيث تفرض غرامات تتناسب مع خطورة الانتهاك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضمان الاجتماعي تحفيز الامتثال لهذه القوانين من خلال تقديم مزايا لأصحاب العمل الذين يلتزمون بحقوق النساء في العمل. على سبيل المثال، يمكن تقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيضات في مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات الملتزمة، مما يخلق حلقة تعزيز إيجابية تشجع على المعاملة العادلة للنساء في بيئة العمل.
علاوة على ذلك، ينبغي أن يتولى الضمان الاجتماعي دورًا أكثر مباشرة في إدارة بعض الجوانب المتعلقة بإجازة الأمومة ورعاية الأطفال. حاليًا، يقع عبء توفير هذه الامتيازات في كثير من الأحيان على أصحاب العمل، مما يشكل رادعًا لتوظيف النساء خصوصا بعد 7 اكتوبر. ومن خلال إنشاء نظام يتولى فيه الضمان الاجتماعي إدارة برامج إجازة الأمومة وتسهيل الوصول إلى خيارات رعاية أطفال ميسورة التكلفة، ينتقل هذا العبء من أصحاب العمل إلى المجتمع ككل. وهذا لا يزيل عقبة كبيرة أمام أصحاب العمل فحسب، بل يضمن أيضًا توفير هذه الامتيازات الأساسية للأمهات العاملات، مما يمكنهن من المشاركة في سوق العمل دون التعرض لضغوط غير ضرورية أو انتكاسات في مسيرتهن المهنية.
ثالثاً – اثر الحرب على تمكين المرأة الاقتصادي
تسببت سيطرة الاحتلال على الموارد والضرائب والتجارة الفلسطينية، إلى جانب الحواجز العسكرية والإغلاق، في ارتفاع البطالة بالضفة الغربية إلى مستويات غير مسبوقة، وانكماش الاقتصاد بنسبة 21.7% (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023). هذه الأزمة أدت إلى تراجع النشاط التجاري وفقدان آلاف الوظائف، خاصة بين النساء، إذ يتم تسريحهن أولًا تحت مبرر أولوية الرجال في الفرص القليلة المتبقية والمقدرة لسوق العمل على استيعاب العاملين المسرحين من الداخل المحتل.
غياب نظام ضمان اجتماعي فاعل فاقم من هشاشة النساء اقتصاديًا. فلو كان قانون الضمان الاجتماعي معمولًا به خلال السنوات الماضية، لتمكن العمال، وخاصة النساء، من الحصول على إعانات بطالة تضمن استمرار دخلهم، مما كان سيحافظ على القوة الشرائية، ويدعم الأعمال التجارية المحلية، ويحد من انهيار الاقتصاد.
في سياق الحروب، غالبًا ما يتم التركيز على الأضرار الاقتصادية والسياسية الكبرى، بينما تبقى معاناة النساء في سوق العمل وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية غير مرئية أو غير مُعترف بها بشكل كافٍ. لا يقتصر تضرر النساء من الحرب على فقدان الوظائف أو انخفاض فرص التوظيف او التخوف من استلام الوظائف البعيدة لانعدام الامان لخصوصيتهن كنساء، بل يمتد إلى أشكال أكثر تعقيدًا من التهميش والاستغلال، مما يجعلهن “ضحايا خفايا” يتحملن عبئًا مضاعفًا دون اعتراف رسمي أو حلول جذرية.
كما أن فقدان الرجال لوظائفهم في القطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب، مثل الصناعة والتجارة والإنشاءات، يفرض ضغطًا إضافيًا على النساء لإعالة أسرهن، غالبًا في ظل موارد محدودة ودون حماية قانونية كافية. هذا يفاقم الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، حيث تصبح النساء عالقات بين الحاجة إلى العمل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وبين العراقيل الهيكلية التي تمنعهن من الوصول إلى فرص عمل عادلة وآمنة.
علاوة على ذلك، في المجتمعات التي تعاني من صراعات ممتدة، تتجذر هذه التحولات الاقتصادية الجندرية، بحيث تصبح النساء أكثر ارتباطًا بالأعمال غير المستقرة أو منخفضة الأجر حتى بعد انتهاء النزاع، مما يحدّ من فرصهن في استعادة موقعهن المهني أو تحسين ظروفهن الاقتصادية.
ختاماً
إن الاستقلال الاقتصادي للنساء ليس مجرد حق، بل هو ضرورة لبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وعدالة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها النساء في فلسطين. فتمكين المرأة اقتصاديًا لا يعني فقط توفير فرص العمل، بل يشمل أيضًا حمايتها من الاستغلال، وضمان حقوقها في سوق العمل، وعدم تهميش طموحاتها المهنية لصالح الأدوار التقليدية التي تفرض عليها التنازل عن حياتها العملية لصالح مسؤوليات أسرية فقط. إن تحقيق هذا التوازن بين الحياة المهنية والأسرية يجب أن يكون خيارًا تدعمه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لا أن يكون عبئًا يدفع النساء إلى التراجع عن أحلامهن.
وفي السياق الفلسطيني، حيث تفرض الظروف الاحتلالية والاقتصادية تحديات مضاعفة، يصبح دعم النساء في القطاعات غير الرسمية أمرًا حيويًا. فالكثير من النساء اضطررن للعمل بطرق غير تقليدية، سواء عبر مشاريع منزلية أو أعمال صغيرة، مما يعكس إصرار المرأة الفلسطينية على تحقيق ذاتها رغم كل القيود. لذا، فإن تعزيز هذه الطموحات وتطويرها من خلال مبادرات مجتمعية مثل إقامة بازارات لتسويق المنتجات المحلية، وتوفير منصات دعم للمشاريع الصغيرة، وتثقيف النساء حول حقوقهن الاقتصادية والمهنية وزرع الثقة بنفوسهم للمطالبة بحقوقهن العمالية، كلها خطوات ضرورية لضمان أن لا يكون عمل المرأة مجرد استجابة مؤقتة للأزمة، بل أساسًا لبناء استقلال اقتصادي مستدام.
لكن هذه الجهود لا يمكن أن تقتصر على حلول مؤقتة أو فردية، بل يجب أن تكون جزءًا من إصلاحات جذرية في السياسات الاقتصادية والتشريعية، بحيث يتم دمج النساء في خطط التنمية بشكل حقيقي، وليس باعتبارهن فئة هامشية أو مستفيدة فقط. فتمكين النساء اقتصادياً ليس قضية فردية، بل هو ركيزة أساسية لمجتمع أكثر تماسكًا، حيث تكون لكل امرأة الفرصة لتحقيق طموحاتها دون أن تواجه خيارًا قاسيًا بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ودون أن تبقى رهينة لاقتصاد هش يجعلها أكثر عرضة للاستغلال.
بقلم الباحثة: ماسة عورتاني
مواضيع أخرى ذات علاقة:
- رقمنة العدالة: هل يستطيع القانون الحاسوبي تغيير وجه القضاء في فلسطين؟.
- حقوق الإنسان والحريات العامة.
- إتفاقية سيداو (CEDAW Convention).
- حقوق الإنسان بين التطبيق والعدم.
- الفلكلور الفلسطيني في ظل التشريعات الوطنية والدولية.
المصادر والمراجع
| ↑1 | Palestine central bureau of statistics https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=5733 |
|---|---|
| ↑2 | Ishizuka, P. (2021). The motherhood penalty in context: Assessing discrimination in a polarized labor market. Demography, 58(4), 1275–1300. https://doi.org/10.1215/00703370-9373587 |
| ↑3 | Salameh, N., Dawas, R., & Qarawi, Z. (2024). Legal Constraints to Protect Working Women: A comparative study under international labor standards and the Palestinian Labor Law. Maǧallaẗ Ǧāmi’aẗ al-Naǧāḥ Li-l-abḥāṭ. Al-ʿulūm Al-insāniyyaẗ/Maǧallaẗ Ǧāmiʿaẗ Al-najāḥ Al-abḥāṭ. Al-ʿul-um Al-insāniyyaẗ, 38(4), 671–708. https://doi.org/10.35552/0247.38.4.2181 |
| ↑4, ↑5 | المرجع السابق |
| ↑6 | Perera, C., Bakrania, S., Ipince, A., Nesbitt‐Ahmed, Z., Obasola, O., Richardson, D., Van De Scheur, J., & Yu, R. (2022). Impact of social protection on gender equality in low‐ and middle‐income countries: A systematic review of reviews. Campbell Systematic Reviews, 18(2). https://doi.org/10.1002/cl2.1240 |

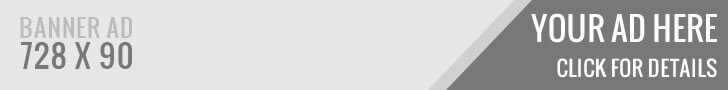







Pingback: العنف ضد النساء في القانون الفلسطيني: قراءة نقدية في ضوء الاتفاقيات الدولية - موسوعة ودق القانونية