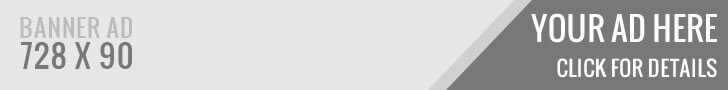المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الفلسطيني
المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الفلسطيني
(بقلم المحامية: أسماء عيسة)
يعد مفهوم المسؤولية التقصيرية من أهم المفاهيم القانونية في فقه القانون المدني، إذ يعد هذا المفهوم أحد المصادر الرئيسية للالتزام، إلى جانب العقد والإثراء بلا سبب والقانون. وهي تشكل الإطار القانوني الذي يمكن المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه نتيجة أفعال الغير مشروعة، دون أن يكون هناك عقد او التزام سابق بين الطرفين.
تعنى المسؤولية التقصيرية بالجانب السلبي من السلوك البشري، إذ تقوم هذه المسؤولية حينما يخل الشخص بالتزام قانوني عام يقضي بعدم الإضرار بالغير، سواء أكان الضرر الذي سببه مادياً أو معنوياً، مباشراً أو غير مباشر.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الفلسطيني شأنها شأن في ذلك القوانين المدنية المقارنة قد أخذت مبادئها من قواعد الفقه الإسلامي، ومن أحكام القانون المصري الذي بدوره تأثر بالقانون المدني الفرنسي، لهذا فإن دراسة المسؤولية التقصيرية في السياق الفلسطيني لها أهمية بالغة وذلك لفهم الإطار القانوني المحلي، ولدراسة مدى ملاءمة القانون للواقع الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني.
أولاً – تعريف المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية هي التزام قانوني ينشأ عن فعل غير مشروع يلحق ضرراً بالغير دون وجود علاقة عقدية مسبقة بين الطرفين، فلا يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها أو الاعفاء منها، والقانون هو الذي يحدد الضرر الذي يشمله التعويض، وتقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
وقد نص قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 وتعديلاته على هذه المسؤولية ضمن إطار الأحكام العامة للالتزام، مؤكداً على وجوب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأفعال الضارة. وأيضا تم تنظيم هذه المسؤولية في مجلة الأحكام العدلية بموجب نص المادة (19): “لا ضرر ولا ضرار”، ونص المادة (20): “الضرر يزال”.
وقد نصت المادة (179) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه “كل من ارتكب فعل سبب ضرراً للغير يلزم بالتعويض”.
ثانياً – أركان المسؤولية التقصيرية
- الركن المادي: المتمثل بالخطأ، وهو عبارة عن عن فعل غير مشروع وتعدي على الغير نشأ عنه ضرر لاحق، ويشمل الخطأ الفعل الإيجابي (كالإعتداء الجسدي) أو الامتناع السلبي (كالترك المتعمد لوسائل السلامة في الأماكن العامة)، ويعد الركن الأول لقيام المسؤولية.
- الركن المعنوي: وهو الركن المكمل للركن المادي وهو يتمثل بالضرر الذي يصيب الغير الحاصل نتيجة للقيام بالخطأ. والضرر قد يكون ماديا كإتلاف مال، وقد يكون معنويا كالمساس بالسمعة أو الكرامة، ويشترط بالضرر أن يكون محققا أو محتملا بشكل راجح.
- العلاقة السببية: لا بد من وجود ترابط بين الخطأ والضرر لقيام المسؤولية التقصيرية، ويجب إثباتها من قبل من قام بالادعاء بوجودها. فإذا انقطعت هذه العلاقة فإن المسؤولية تنتفي، ما لم يكن هناك ما يسمى بالسبب الأجنبي.
ثالثاً – آثار المسؤولية التقصيرية
الأثر الرئيسي للمسؤولية التقصيرية هو التعويض، حيث يلتزم الفاعل بتعويض المتضرر عن الخسائر التي لحقت به، ويقدر عادة بما يعادل الضرر الواقع، وقد يشمل التعويض المالي عن الأضرار الأدبية في بعض الحالات. ويكون التعويض إما نقدي ويكون بدفع مالي من المدعى عليه إلى المدعي بقيمة الضرر الحاصل. وقد يكون تعويض غير نقدي وهذه الحالة يلجأ إليها القاضي في حالات واردة على سبيل الحصر وهما: إعادة الحال إلى ما كان عليه أو القيام بأمر معين يعوض عن الضرر الحاصل.
رابعاً – انتفاء المسؤولية التقصيرية
بإمكان المدعى عليه أن ينفي مسؤوليته التقصيرية عن طريق إثبات أحد الأسباب التالية:
- في حال وجود قوة قاهرة وهي عبارة عن حادث غير متوقع.
- إثبات انتفاء وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
- خطأ المتضرر.
- حالة الدفاع الشرعي: ففي حال ارتكب شخص فعلا أضر بالغير في إطار دفاعه عن نفسه او عن ماله أو عن غيره ضد اعتداء غير مشروع فلا يعد مخطئا.
خامساً – الخاتمة
تمثل المسؤولية التقصيرية أحد الضمانات القانونية المهمة لحماية الأفراد من الأفعال الضارة التي تصدر عن الغير دون علاقة تعاقدية، وهي تكرس مبدأ العدالة والتعويض عن الضرر في المجتمع الفلسطيني، وتبقى الحاجة قائمة لتعزيز النصوص القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي بما يكفل الحماية الفعالة للمتضررين ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
بقلم المحامية: أسماء عيسة
مواضيع أخرى ذات علاقة: