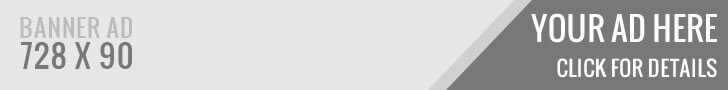فلسفة التكنولوجيا في سياق التبعية الرقمية: قراءة فلسطينية
فلسفة التكنـولوجيا في سياق التبعيـة الرقميـة:
قراءة فلسطينيـة
(بقلم الباحثة: ماسة عورتاني)
في ظل التسارع الكبير في التطور التكنولوجي العالمي، وخصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، تواجه المجتمعات المهمشة مثل فلسطين تحديات معقدة لا تتوقف عند نقص الوصول إلى التكنولوجيا، بل تمتد إلى الأبعاد الفلسفية والسياسية التي تحكم هذا التطور. في الحالة الفلسطينية، لا يمكن فهم التكنولوجيا بشكل محايد، فهي ترتبط بشكل وثيق بمنظومات الهيمنة والرقابة التي تتجذر في السياق الاستعماري. إن الحتمية التكنولوجية، باعتبارها الفكرة القائلة بأن التكنولوجيا تملي مسار المجتمعات وتعيد تشكيل القيم والسياسات، تُسهم في تهميش الأصوات المحلية، عبر فرض نماذج معرفية وتقنية غربية تُقدّم بوصفها “الطبيعة الحتمية للتقدم”.
يتقاطع ذلك مع مفهوم “الاستعمار التكنولوجي” الذي يُعيد إنتاج علاقات السيطرة من خلال البنية التحتية الرقمية، وتحليل البيانات، والخوارزميات، ما يجعل من التكنولوجيا امتدادًا للاستعمار الكولونيالي لا قطيعة معه. وفي السياق الفلسطيني، حيث يُعاد تعريف الحدود والهوية والحركة والمقاومة من خلال أدوات مراقبة ذكية وأنظمة تصنيف خوارزمية، يصبح من الضروري مساءلة التكنولوجيا ليس فقط كأداة، بل كبنية سلطوية تُعيد ترسيخ منطق الاستعمار في شكل رقمي جديد.
أولاً – الحتمية التكنولوجية: التكنولوجيا كمحدد لمسار المجتمعات
في قلب النقاشات المعاصرة حول التكنولوجيا والمجتمع، تبرز “الحتمية التكنولوجية” كمفهوم إشكالي متشعب يقوم على افتراض أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة يستخدمها الإنسان، بل هي قوة مستقلة تمتلك تأثيرًا حاسمًا على بنية المجتمعات ومساراتها التاريخية. وبهذا المعنى، تتحول التكنولوجيا من وسيلة إلى بنية فكرية وسلطة مادية تُعيد تشكيل القيم والسياسات والأنظمة القانونية على نحو يرسّخ علاقات الهيمنة والسيطرة.
وفقًا لما يطرحه دوسيك (Dusek)، لا تقتصر الحتمية التكنولوجية على التأثير التقني في البنى الاجتماعية، بل تمتد لتشكل سردية سياسية وأيديولوجية تُستخدم عمدًا لإضفاء طابع “طبيعي” أو “حتمي” على التقدم التكنولوجي، مما يؤدي إلى تجريد الأفراد والمجتمعات من قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية تجاه أدوات التقنية وأطرها التنظيمية. وتُصبح التكنولوجيا في ظل هذا التصور كيانًا مفروضًا من الخارج لا يُمكن مساءلته اجتماعيًا أو قانونيًا، بل يُفترض التكيّف معه دون نقد أو مقاومة.[1]Hallström, J. Embodying the past, designing the future: technological determinism reconsidered in technology education. Int J Technol Des Educ 32, 17–31 (2022). … Continue reading
غير أن هذا التصور يغفل السياقات التاريخية والسياسية التي تتحكم في إنتاج التكنولوجيا وتوزيعها عالميًا ويُعيد إنتاج خطاب يُشرعن الفجوة التكنولوجية بين الدول الغنية والفقيرة باعتبارها نتيجة “تخلّف طبيعي”، بدلًا من الاعتراف بها كنتيجة مباشرة لعلاقات استعمارية واقتصادية غير متكافئة. فغياب التكنولوجيا أو ضعف البنية الرقمية في كثير من دول الجنوب لا يُعد فشلًا داخليًا، بل انعكاسًا لتاريخ طويل من التبعية المعرفية والاقتصادية، ومن فرض نماذج “تحديث” غربية لم تراعِ الحاجات أو الخصوصيات المحلية.
وفي هذا السياق، تُسهم الشركات التقنية العالمية والأنظمة السياسية المهيمنة في تعزيز هذا الفهم، من خلال تقديم الأنظمة الرقمية، وخاصة الخوارزميات، كبُنى غامضة ومعقّدة وغير شفافة، ما يجعل من الصعب مساءلتها قانونيًا أو إدماجها ضمن منظومات عدالة محلية. وهنا تتعمق العلاقة بين التكنولوجيا والسلطة، حيث تُقدّم السيادة الرقمية كامتياز حصري للدول المتقدمة، بينما تُدفع الدول الفقيرة نحو استهلاك التكنولوجيا لا إنتاجها، فيصبح الاعتماد على الخارج أمرًا “محتومًا”.
وهكذا، تبرّر الحتمية التكنولوجية شكلًا جديدًا من التبعية التقنية، حيث يُطلب من المجتمعات المُهمّشة “اللحاق” بالركب، لا باعتبارها فاعلًا قادرًا على إنتاج نماذج تكنولوجية بديلة، بل كمستهلك يتقبل ما يُنتج له. هذا الوضع يخلق ما يمكن وصفه بـعالم تكنولوجي من درجة ثانية، حيث تُستورد الحلول التقنية جاهزة، دون امتلاك القدرة على فهم بنيتها الداخلية، أو التحكم فيها، أو تعديلها بما يتلاءم مع السياقات الاجتماعية والقانونية المحلية.
ثانياً – الاستعمار التكنولوجي: إعادة إنتاج الهيمنة عبر الأدوات الرقمية
يُشبه هذا الاستعمار العلاقة الكلاسيكية بين المركز (الدول الغنية) والهامش (الدول الفقيرة) حيث تُعيد صناعة الذكاء الاصطناعي إنتاج أنماط من التبعية الاقتصادية والمعرفية تُشبه من حيث البنية — وإن اختلفت في الوسائل — الممارسات الاستعمارية الكلاسيكية. فهي لا تقوم على العنف المباشر، بل على فرض نماذج رقمية تخدم مصالح القوى الكبرى، وتعزز فجوة الهيمنة بين المركز والأطراف تحت غطاء “الابتكار” والتقدم.[2]Hao, K. (2022, April 22). Artificial intelligence is creating a new colonial world order. MIT Technology Review. … Continue reading اي تحتكر الدول المتقدمة أدوات إنتاج التكنولوجيا (مثل معالجات الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات، والسيرفرات الكبرى)، بينما تُحوَّل الدول الفقيرة إلى أسواق استهلاكية أو مواقع لتجريب التكنولوجيا دون ضمانات للسيادة أو الخصوصية. وغالبًا ما تُفرَض نماذج “ذكية” على مجتمعات لا تُراعى فيها الخصوصيات الثقافية، ولا تُفتح فيها نقاشات ديمقراطية حول دور التكنولوجيا ما يجعل من هذه الأدوات امتدادًا لمنظومة استعمارية معرفية. في هذا السياق، تطرح مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في تقريرها حول “الذكاء الاصطناعي العابر للحدود والإمبريالية الشركاتية” تصورًا نقديًا لهذا النمط الجديد من السيطرة التقنية، موضّحةً كيف تتجلى هذه الإمبريالية الرقمية في عدد من المظاهر البنيوية.
أولاً، أصبحت بها شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Meta وOpenAI، جهات فاعلة على المستوى الجيوسياسي، حيث تقوم بتصميم نماذج ذكاء اصطناعي على أساس تصورات ثقافية وقيمية غربية، ثم تعممها كمعايير “عالمية” على باقي العالم، متجاهلة السياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات الأخرى، وخاصة في دول الجنوب العالمي. لا تُقدَّم هذه النماذج كخيارات، بل يتم تسويقها باعتبارها “طبيعة الأشياء” و”السبيل الوحيد نحو الحداثة”، مما يؤدي إلى تغريب السياقات المحلية وتحويل المستخدمين في الدول النامية إلى مجرد مستهلكين لمنتجات معرفية لم يشاركوا في إنتاجها أو توجيهها.
ثانيًا، يتحدث المقال عن ظاهرة تُسمّى “استعمار البيانات”، حيث تعتمد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى على عمال من دول الجنوب، مثل كينيا، لتأدية أعمال حيوية في عملية تدريب النماذج، مثل تصنيف الصور والمحتوى، مقابل أجور زهيدة جدًا (أحيانًا أقل من دولارين في الساعة). هذه العمالة غير الظاهرة تُعتبر العمود الفقري لما يُعرف بـ”التعلم الآلي”، ومع ذلك، يتم تجاهل وجودها في الخطاب العام الذي يُروّج لفكرة أن الذكاء الاصطناعي يتعلم “بشكل ذاتي” دون تدخل بشري. هذا الإخفاء المنهجي للجهد البشري يعكس نمطًا استعماريًا معرفيًا جديدًا، حيث يُستغل العمل في الجنوب العالمي من أجل خدمة ابتكارات تُستثمر أرباحها ومكانتها الرمزية في الشمال العالمي.
ثالثا، لا تقتصر هيمنة هذه الشركات على أدوات الإنتاج المعرفي، بل تمتد إلى التأثير على التشريعات الوطنية والسياسات العامة، خاصة في الدول التي تفتقر إلى بنى قانونية قوية قادرة على تنظيم عمل شركات الذكاء الاصطناعي. فبفضل علاقاتها العابرة للحدود وقدرتها على الضغط الاقتصادي، تؤثّر هذه الشركات في شكل القوانين المقترحة، بل وتساهم أحيانًا في صياغتها، بما يضمن مصالحها ويقلّص من فرص إخضاعها للمحاسبة المحلية.[3]Transnational AI and corporate imperialism. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/research/2024/10/transnational-ai-and-corporate-imperialism?lang=en
اذن، المجتمعات المهمشة لا تُستبعد من الثورة الرقمية بسبب “تأخرها”، بل لأن البنى التقنية نفسها صُمّمت لتخدم مصالح محددة وتُعيد إنتاج التراتبية العالمية. وفي هذا السياق لا تُعد التكنولوجيا بريئة أو محايدة، بل تحمل في طياتها تصورًا معينًا للعالم، ولما يجب أن يكون عليه “التقدم” و”الحداثة”. اي إن الاستعمار التكنولوجي لا يكمن فقط في تصدير أدوات من الخارج، بل في تصدير نماذج فكرية كاملة تُقصي الرؤى البديلة وتُخضع السياقات المحلية لمنطق تقني خارجي يُقدَّم كقدر لا مفر منه
ثالثاً – السياق الفلسطيني
بالنظر إلى السياق الفلسطيني، فإن الاستعمار التكنولوجي والحتمية التكنولوجية يأخذان أبعادًا شديدة التعقيد تتقاطع فيها الهيمنة الرقمية مع الاحتلال العسكري والامبريالية الامريكية. ففلسطين لا تعاني فقط من فجوة تقنية ناتجة عن التبعية في إنتاج وتطوير التكنولوجيا، بل تواجه واقعًا مركّبًا يتمثل في استخدام التكنولوجيا كأداة استعمارية فعلية. الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي باحتكار البنى التحتية الرقمية ومنع الفلسطينيين من تطوير شبكات مستقلة، بل يستخدم أدوات المراقبة المتقدمة، مثل أنظمة التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، لمراقبة الحياة اليومية للفلسطينيين، وتحديد أنماط تحركهم، بل وتوقّع “السلوك الخطر” استنادًا إلى معايير خوارزمية مبهمة. وهذا يجعل من التكنولوجيا في فلسطين ليست مجرد أداة تنظيمية، بل سلاحًا ضمن منظومة السيطرة الاستعمارية.
في هذا الإطار، تبرز تحديات قانونية خاصة تتعلق بغياب السيادة الرقمية الفلسطينية، إذ لا تملك السلطة الفلسطينية أو المؤسسات المحلية أي قدرة حقيقية على وضع تشريعات مستقلة لحماية البيانات أو تنظيم استخدام الخوارزميات، ما يجعل المواطنين الفلسطينيين عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الرقمية دون أي مسار قانوني للمساءلة أو التعويض. كما أن غياب البنية القانونية والتقنية للحوسبة السحابية، وتبعية الاتصالات الرقمية لشركات إسرائيلية أو عالمية، يقوّض الحق في الخصوصية والحرية الرقمية. في ظل هذه التحديات، تصبح الحتمية التكنولوجية في السياق الفلسطيني ليست فقط مسألة فلسفية أو تنموية، بل قضية قانونية وحقوقية ترتبط جوهريًا بالنضال من أجل التحرر الوطني والسيادة السياسية والقانونية على الفضاء الرقمي.
في ظل هذه المعطيات، يصبح تطوير بنى قانونية محلية وإقليمية قادرة على التعامل مع تحديات الاستعمار التكنولوجي ضرورة، لا رفاهية، خاصة في المجتمعات التي تعاني أصلاً من هشاشة سياسية واقتصادية مثل فلسطين، وهذه بعض المقترحات للتصدي لتلك التحديات:
- تعزيز مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر
بدلًا من الاعتماد على برمجيات مغلقة خاضعة لسيطرة شركات أجنبية، يمكن إنشاء مبادرات مجتمعية لتطوير برمجيات فلسطينية مفتوحة المصدر، تلبي حاجات المستخدمين المحليين وتقلل من الاعتماد على خدمات تخزّن البيانات خارج السيطرة. هذا يعزز أمن المعلومات ويفتح المجال لبناء خبرة تقنية محلية طويلة الأمد.
- إنشاء مراكز بيانات محلية (Data Centers)
من أهم مظاهر التبعية التكنولوجية أن البنية التحتية للإنترنت الفلسطيني مرتبطة مباشرة بالبنية الإسرائيلية، بما في ذلك تخزين البيانات ومرورها عبر الشبكات. بناء مراكز بيانات فلسطينية، ولو على نطاق صغير، قد يشكل خطوة نحو امتلاك بياناتنا والتحكم بها، وتقليل احتمالية التجسس أو التحكم الخارجي.
- تعليم التكنولوجيا من منظور نقدي واستقلالي
إدماج مساقات تعليمية في الجامعات والمدارس الفلسطينية تتناول التكنولوجيا من منظور نقدي، تطرح مفاهيم مثل التبعية التقنية، الاقتصاد الرقمي، احتكار المعرفة الرقمية، وتدفع باتجاه تعليم المهارات التقنية كأداة تمكين ذاتي لا فقط استهلاك تكنولوجي.
- تشجيع الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا
رغم ضعف التمويل، يمكن للمؤسسات المحلية والجامعات أن تدعم الرياديين الفلسطينيين من خلال حاضنات أعمال تركّز على تقديم حلول محلية، خصوصًا في مجالات الصحة، التعليم، والتجارة الرقمية. التركيز على حاجات المجتمع الفلسطيني يمكن أن يولّد ابتكارًا مستقلًا يلبّي الاحتياجات دون اللجوء إلى شركات تفرض شروطًا خارجية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في التعاقدات التقنية الحكومية
في ظل اعتماد الحكومة الفلسطينية على شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع رقمية، يجب فرض معايير واضحة للمساءلة والشفافية عند توقيع هذه التعاقدات، وضمان أن تكون هناك بدائل محلية أو شروط تحفظ الحد الأدنى من السيادة على البيانات والخدمات الرقمية.
في الختام، يتعين على المجتمعات التي تعاني من التبعية التكنولوجية، مثل فلسطين، أن تسعى جادة نحو تجاوز النموذج الاستهلاكي الذي تفرضه مراكز القوة التقنية العالمية مثل وادي السيليكون أو شينزين. إن التطلع إلى تحقيق مصير رقمي مستقل يعد أمرًا حيويًا ليس فقط لتعزيز السيادة الرقمية، بل لضمان حماية خصوصيات الأفراد وحقوقهم في بيئة تزداد فيها الرقابة الرقمية. من خلال تعزيز البحث المحلي، وتطوير بنى قانونية وتقنية تواكب التحديات المتجددة، يمكن لهذه المجتمعات أن تضع الأسس لاستقلالها الرقمي، بعيدًا عن هيمنة النماذج الغربية التي لا تراعي خصائصها الثقافية والاجتماعية. هذا هو التحدي الحقيقي أمامنا: الابتكار والتطوير المحلي الذي يعكس احتياجاتنا وواقعنا، ويعزز قدرتنا على المشاركة الفاعلة في الثورة الرقمية بشكل آمن ومستدام.
بقلم الباحثة: ماسة عورتاني
مواضيع أخرى ذات علاقة:
- تأثير التكنولوجيا على الخصوصية والحقوق الفردية.
- التحديات القانونية في التكنولوجيا الحديثة: ما هي المسائل القانونية المطروحة؟.
- رقمنة العدالة: هل يستطيع القانون الحاسوبي تغيير وجه القضاء في فلسطين؟.
- الذكاء الاصطناعي: التحول القانوني القادم.
- تحليل الإطار القانوني في الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص.
- دور وسائل الإعلام في نشر الجريمة والوقاية منها.
المصادر والمراجع
| ↑1 | Hallström, J. Embodying the past, designing the future: technological determinism reconsidered in technology education. Int J Technol Des Educ 32, 17–31 (2022). https://doi.org/10.1007/s10798-020-09600-2 |
|---|---|
| ↑2 | Hao, K. (2022, April 22). Artificial intelligence is creating a new colonial world order. MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/2022/04/19/1049592/artificial-intelligence-colonialism/ |
| ↑3 | Transnational AI and corporate imperialism. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/research/2024/10/transnational-ai-and-corporate-imperialism?lang=en |