العنف ضد النساء في القانون الفلسطيني: قراءة نقدية في ضوء الاتفاقيات الدولية
العنـف ضـد النسـاء في القانـون الفلسطيني:
قراءة نقدية في ضوء الاتفاقيات الدولية
(بقلم الباحثة: آلاء تيسير طيبي)
رغم كل ما أحرز من تقدم على صعيد حقوق المرأة عالمياً لا تزال كثير من النساء بالعالم، وخصوصاً في المجتمعات التي تعاني من الاحتلال أو النزاعات، يعشن في ظل عنف ممنهج يتخذ أشكالاً متعددة: جسدية، نفسية، اقتصادية، قانونية. ويعد العنف ضد النساء من أخطر مظاهر التمييز التي تهدد ليس فقط حياة المرأة وسلامتها بل أيضاً استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله.
في السياق الفلسطيني تزداد خطورة هذه الظاهرة نتيجة تعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، مما يجعل من الصعب تحقيق حماية فعالة للنساء، حتى مع وجود بعض النصوص القانونية التي يفترض أن توفر هذه الحماية. ومع انضمام فلسطين الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، برزت تساؤلات ملحة : هل يكفي مجرد الانضمام للاتفاقيات الدولية لحماية النساء من العنف؟ وهل التشريعات الوطنية القائمة تتماشى حقاً مع هذه الالتزامات؟ أم أن هناك فجوة واسعة بين النصوص والواقع؟
ينطلق هذا المقال من هذه التساؤلات ليقدم قراءة قانونية نقدية للمنظومة التشريعية الفلسطينية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء، في ضوء المعايير الدولية، مع تحليل دقيق للواقع العملي وتقديم توصيات تهدف الى تطوير الإطار القانوني بما يحقق العدالة والكرامة الإنسانية للمرأة الفلسطينية.
أولاً – مفهوم العنف ضد النساء: نظرة قانونية دولية ووطنية
يشكل العنف ضد النساء أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهود الدولية والوطنية لحماية حقوق الانسان، لما يحمله من تهديد مباشر للكرامة الإنسانية، ويعد انعكاساً واضحاً لاختلال ميزان القوى بين الرجل والمرأة في المجتمع. وقد عرفت الاتفاقيات الدولية هذا النوع من العنف بشكل واضح، واعتبرته أحد أشكال التمييز الذي يجب القضاء عليه.
نصت المادة (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على أن التمييز ضد المرأة يشمل:
“أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، يكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرية الأساسية أو تمتعها بها أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة “.
ورغم أن الاتفاقية لم تذكر مصطلح “العنف” بشكل صريح في نصوصها الاصلية، فإن التوصية العامة رقم (19) الصادرة عن اللجنة المعنية بسيداو عام 1992 أوضحت بأنه : “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه أذى أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية للمرأة، ويشمل التهديد بهذه الأفعال أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
أما على الصعيد الوطني، فإن القوانين الفلسطينية (سواء في الضفة الغربية التي تطبق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، أو قطاع غزة الذي يطبق قانون العقوبات البريطاني لسنة 1936 وما لحقه من تعديلات وقوانين)، لا تحتوي على تعريف قانوني صريح للعنف ضد النساء، ولا تفرق في كثير من الأحيان بين العنف العام وبين العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يترك المجال مفتوحاً لتفسير النصوص حسب إجتهاد القضاة أو الأعراف المجتمعية.
ويعتبر هذا الغياب إشكالية قانونية خطيرة ،لأنه يضعف من أدوات الوقاية والملاحقة القانونية، ويجعل النساء أكثر عرضة لإفلات الجناة من العقاب، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالعنف الأسري أو “جرائم الشرف”.
ووفقاً لتقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2022 فإن:
- نحو 29% من النساء الفلسطينيات المتزوجات تعرضن لأحد أشكال العنف من أزواجهن خلال العام.
- بينما صرحت 60% من النساء المعنفات أنهن لم يقمن بالإبلاغ عن العنف إما خوفاً من العار، أو بسبب ضعف الثقة بالمنظومة القانونية.
تؤكد هذه الإحصائيات أن غياب تعريف قانوني دقيق ووجود تشريعات قديمة غير مواءمة مع المعايير الدولية يساهم في تفاقم الظاهرة وإستمرارها دون حلول جذرية.
ثانياً – قراءة نقدية في التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالعنف ضد النساء
رغم تصاعد الخطاب الرسمي حول ضرورة حماية النساء من العنف في فلسطين، إلا أن المنظومة التشريعية الوطنية لاتزال إلى حد بعيد، أسيرة قوانين قديمة غير منسجمة مع تطورات المجتمع ولا مع إلتزامات الدولة الفلسطينية الدولية، وعلى رأسها إتفاقية سيداو. هذه التشريعات بدل أن تشكل درعاً واقياً للنساء، غالباً ما تعكس منطقاً قانونياً تقليدياً يفرغ الحماية من مضمونها.
في الضفة الغربية، لا يزال قانون العقوبات الأردني رقم 16 سنة 1960 سارياً، وهو قانون وضع قبل أكثر من ستة عقود في سياق في سياق إجتماعي وقانوني مختلف تماماً عن واقع المرأة الفلسطينية اليوم.
وتبرز في هذا القانون عدة مواد تعكس رؤية ذكورية مبنية على تساهل مع مرتكبي العنف ضد النساء، حيث انه لطالما شكلت المادتان 340 و 98 من قانون العقوبات مظلة قانونية غير مباشرة للتساهل مع مرتكبي جرائم العنف ضد النساء، تحت ذريعة “الدافع الشريف” أو “حماية الشرف”. ورغم أن المادة 340 التي منحت عذراً مخففاً في جرائم الشرف قد ألغيت رسمياً بقرار بقانون رقم 16 سنة 2018 ورغم أن المادة 98 تستثني صراحة حالات القتل على خلفية الشرف من الاستفادة من العذر المخفف، إلا أن الإشكالية لم تحل تماماً. ذلك أن بعض الأحكام لا تزال في الممارسة القضائية، تضفي طابعاً تبريرياً على جرائم قتل النساء من خلال تأويل مرن لمصطلحات مثل ” الإستفزاز الشديد” أو “رد الفعل الفوري” ، مما يعيد إنتاج نفس التساهل لكن بأدوات قانونية مختلفة.
وهنا تظهر المفارقة: إلغاء النص لا يكفي ما دام تطبيق القانون يخضع لعقلية تبريرية موروثة، وما لم يرافقه تدريب عميق للقضاة وأجهزة إنفاذ القانون على فهم النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
أما في قطاع غزة، فما زال قانون العقوبات البريطاني لسنة 1936 يشكل المرجع الأساسي في التعامل مع الجرائم، رغم قدمه وضعف ملاءمته للواقع الحقوقي المعاصر. فهذا القانون، الذي وضع في زمن الانتداب البريطاني لا يتضمن أي أحكام صريحة تتعلق بالعنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا يعترف بمفاهيم الحماية الحديثة للمرأة مما يجعله عاجزاً عن مواكبة طبيعة الجرائم المعاصرة والإحتياجات الخاصة للنساء المعنفات.
وتزداد المشكلة تعقيداً في ظل غياب قانون موحد لحماية الأسرة من العنف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم جهود حقيقية لصياغة مسودة قانون حماية الأسرة عام 2019 التي تضمنت أدوات حماية متقدمة وإعترافاً صريحاً بالعنف الأسري، واجهت إعتراضات مجتمعية ودينية شرسة، وأتهمت بأنها تمس البنية التقليدية للأسرة، ما دفع الى تجميدها بدل تطويرها أو تحسينها. هذه الحالة تكشف خللاً مزدوجاً في النظام القانوني الفلسطيني في ضعف الإرادة السياسية لسن تشريعات جريئة ومحدثة من جهة، وسيطرة الذهنية المحافظة في صناعة القرار القانوني من جهة أخرى ، والتي تحجم أي محاولة لتوفير حماية خاصة للنساء. والأسوأ من ذلك أن إتفاقية سيداو، رغم إنضمام فلسطين إليها دون تحفظات، لم تفعل فعلياً داخل النظام القانوني الوطني. فغياب نص دستوري صريح يمنح الإتفاقيات الدولية أولوية على التشريعات المحلية، جعل من التزامات الدولة في هذا المجال مجرد إعلان نوايا بلا قوة قانونية حقيقية. وعليه فإن النظام القانوني الفلسطيني لا يعاني فقط من تأخر في التشريع، بل من عجز بنيوي ووظيفي مركب:
- عجز بنيوي: يظهر في بقاء قوانين قديمة لا تعترف بمفهوم العنف القائم على النوع.
- عجز وظيفي: يتجلى في غياب آليات التطبيق والتردد في سن قوانين فعالة تحمي النساء.
وفي ضوء ذلك، يمكن القول بوضوح أن القانون الذي لا يميز العنف ضد النساء كجريمة نوعية، ولا يمنح النساء أدوات حماية خاصة، هو قانون يخون مهمته الأساسية في تحقيق العدالة. فغياب النص لا يعني حياد الدولة بل تواطؤاً صامتاً مع إستمرار العنف وتجاهل ممنهج لمعاناة لا يجب أن تكون موجودة.
ثالثاً – مدى إنسجام القوانين الفلسطينية مع الإتفاقيات الدولية
تتفاخر الخطابات الرسمية بإنضمام فلسطين الى عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي انضمت اليها فلسطين رسمياً في 1 نيسان/ ابريل 2014 دون ابداء أي تحفظات ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو من نفس العام. ورغم أن هذه الخطوة شكلت حينها إنجازاً رمزياً في مسار الاعتراف الدولي بالكيان الفلسطيني، إلا أن المعضلة الحقيقية لا تكمن في الانضمام، بل في الفجوة العميقة بين الالتزام الشكلي والتنفيذ العملي.
فمن الناحية القانونية، يفترض أن يؤدي الانضمام إلى سيداو إلى مراجعة جذرية للتشريعات الوطنية، تشمل تعديل أو إلغاء أي نصوص قانونية تمييزية، وسن قوانين جديدة تُجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، إنسجاماً مع المادتين (2) و(5) من الاتفاقية، اللتين تلزمان الدول الأعضاء بإتخاذ تدابير تشريعية وتربوية وثقافية للقضاء على التمييز والانماط الاجتماعية السلبية المرتبطة بالنوع الاجتماعي. إلا أن تفحص الواقع الفلسطيني يظهر أن هذه الالتزامات لم تفعل تشريعياً بالشكل المطلوب. فالقوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تزال تفتقر الى تعريف صريح للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا توجد حماية قانونية مستقلة ولا محاكم متخصصة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء، ما يجعل البيئة القانونية غير مهيأة لتقديم الحماية الفعلية.
ونتيجة لذلك نرى إهمال المؤسسات القضائية والأمنية تفعيل سيداو في قراراتها، وتستمر في تطبيق قوانين محلية قد تكون متناقضة مع روح الاتفاقية، بل إن بعض القضايا الحرجة مثل الاغتصاب الزوجي أو العنف الاقتصادي، تعامل أحياناً كخلافات خاصة أو يسقطها إسقاط الحق الشخصي، دون مساءلة جنائية حقيقية.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن التوافق بين القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لا زال شكلياً وهشاً، وأن الانضمام الى المعاهدات، مهما بدا خطوة تقدمية، يفقد معناه ما لم يُترجم إلى إصلاحات قانونية ومؤسساتية حقيقية تضمن العدالة والحماية والكرامة للنساء، لا بمجرد التوقيع بل بالفعل الملموس.
رابعاً – قراءة في الواقع العملي لحماية النساء في فلسطين: بين النص والتطبيق
اذا كانت النصوص القانونية تمثل وجه النظام القانوني، فإن الواقع العملي هو مرآة صدقه واختباره الحقيقي. وفي الحالة الفلسطينية، يبدو أن الفجوة بين التشريع والتطبيق ليسا مجرد خلل إداري، بل مشكلة بنيوية تمس ثقة النساء بمنظومة العدالة ككل.
فعلى الرغم من وجود بعض المواد في قانون العقوبات تُجرم الضرب والتهديد والاعتداء، إلا أن طريقة تطبيق هذه النصوص تعكس توجهاً محافظاً يقلل من جدية العنف ضد النساء، ويعامله غالباً كمسألة “أسرية” داخلية يفضل حلها بالتسويات أو “العطوة” بدل القانون، حتى عندما يصل الى مستويات تهدد الحياة. ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (2022) :
- صرحت نحو 60% من النساء المعنفات بأنهن لم يبلغن عن العنف الذي تعرضن له.
- وكان السبب الأبرز هو “عدم الثقة بالشرطة أو القضاء”، يليه “الخوف من الفضيحة” أو “العار المجتمعي”.
هذا الرقم بحد ذاته يظهر أن القانون لم يُمارس فعلياً، وعاجز عن توفير الحماية الآمنة للمرأة، لأن العدالة لا تبدأ بالنصوص، بل تبدأ من قدرة الضحية على الوصول لها دون خوف أو لوم. ولعل من مظاهر القصور في الواقع الفلسطيني:
- غياب مراكز حماية مؤهلة بشكل فعلي للتعامل مع النساء المعنفات، سواء من ناحية البنية التحتية أو الكوادر البشرية أو مستوى الأمان المطلوب.
- ضعف تدريب رجال الامن والنيابة على التعامل مع قضايا العنف من منظور حساس للنوع الاجتماعي.
- غياب وحدات متخصصة في الشرطة أو القضاء تعنى حصراً بالعنف الاسري.
- بطء الإجراءات القانونية، ما يؤدي أحياناً إلى إعادة الضحية الى نفس البيئة الخطرة قبل صدور أي حكم.
بل إن بعض الحالات تظهر إستخدام القانون نفسه كأداة ضغط على الضحايا، من خلال التهديد بسحب الحضانة، أو رفع دعاوى “تشهير” ضد المرأة التي تبلغ عن العنف. ولا يمكن إغفال التأثير السلبي للخطاب المجتمعي والديني المحافظ، الذي يحمل المرأة مسؤولية العنف الواقع عليها، ويشيطن فكرة طلبها للحماية أو الخروج عن الصمت. هذا المناخ الثقافي يضعف فعالية أي نص قانوني ويجعل تطبيق القانون مرهوناً بعوامل غير قانونية بالأساس. وبالتالي فإن المعضلة في فلسطين لا تكمن فقط في النصوص الناقصة، بل في منظومة عدالة لاتزال تعاني من ذكورية مستبطنة في سلوكها، وقصور مؤسسي في حمايتها، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لا للمواد القانونية فحسب، بل لكيفية فهمها وتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
خامساً – الخاتمة
في الحالة الفلسطينية، حيث تتقاطع معاناة المرأة مع الاحتلال والسياسات القمعية والقيود المجتمعية، فإن الصمت القانوني لا يكون حياداً، بل يصبح شريكاً خفياً بالجريمة.
لقد أظهر هذا المقال بوضوح أن التشريعات الوطنية ما زالت تفتقر للرؤية الجندرية وتعجز عن عن مواكبة التزامات الدولة الدولية، وأن ما نحتاجه ليس فقط “نصوصاً جديدة”، بل عقلية قانونية جديدة ترى المرأة كمواطنة كاملة لا كموقع هش في ميزان الأعراف. فالقانون الذي لا ينصف المرأة، هو قانون ناقص العدالة، وإن بدا مكتمل البنود. لن تكسر دورة العنف بالنوايا وحدها، بل بكسر صمت القانون، وتحويل الاتفاقيات الدولية من التزامات شكلية الى أدوات فعلية للتغيير، ومن بنود مؤجلة الى واقع ملموس، فإما أن يكون القانون حامياً للضحية، أو شريكاً غير مباشر في إستمرار الانتهاك.
سادساً – توصيات الباحثة
- تسريع إقرار قانون حماية الاسرة من العنف بصيغة متوازنة تراعي الاتفاقيات الدولية والسياق المحلي، دون تمييع الحماية أو تسييسها.
- مراجعة قانون العقوبات وإلغاء المواد التي تمنح أعذاراً مخففة أو تمييزية في جرائم العنف ضد النساء.
- إنشاء وحدات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تدريب كوادرها على آليات الاستجابة الفعالة وإنشاء محاكم الأسرة.
- إدماج اتفاقية سيداو بشكل صريح في التشريع الوطني، وضمان مرجعيتها المباشرة أمام المحاكم.
- تكثيف حملات التوعية المجتمعية والإعلامية التي تعيد تعريف العنف، وتكسر حاجز الصمت والخوف وتعزز ثقافة المساءلة.
- تعزيز وتشجيع توفير الدعم قانوني مجاني للضحايا من خلال مؤسسات الدولة أو بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
بقلم الباحثة: آلاء تيسير طيبي
مواضيع أخرى ذات علاقة:

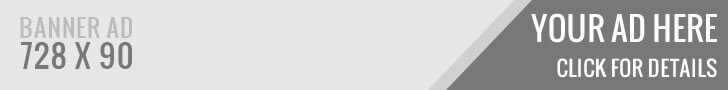







❤️ برافو مقالة رائعة