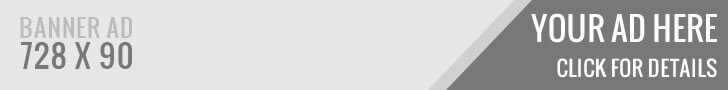قراءة قانونية لظاهرة العمولة: بين الضرورة والاستغلال
قراءة قانونية لظاهرة العمولة: بين الضرورة والاستغلال
(بقلم الباحثة: أشجان رائد الشريف)
في ظل العدوان الغاشم المستمر منذ أكثر من سنة ونصف، ومع الانهيار الشامل للبنية التحتية وتوقف المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها القطاع المصرفي، ظهرت ممارسات مالية غير رسمية فرضت على الناس كأمرٍ واقع.
ومن أبرز هذه التصرفات ما يعرف بـ “العمولة على السحب”، حيث تُفرض عمولات مرتفعة مقابل تمكين المواطنين من الوصول إلى أموالهم، مما يفتح الباب أمام إشكالية قانونية وأخلاقية تدفع للتساؤل: هل هي استجابة لضرورة قاهرة؟ أم شكل من أشكال الاستغلال الفجّ لحاجة الناس؟
أولاً – مفهوم الضرورة في السياق القانوني
الضرورة في اللغة تعني الحاجة المُلحّة أو المشقة الشديدة التي لا مفر منها. أما في الاصطلاح الشرعي والقانوني تعني الحالة التي تُجبر الفرد على ارتكاب فعل محظور أو مخالف للقانون، دفعا لضرر أكبر، مع ضرورة مراعاة أن تُقدّر بقدرها، وألا تُتخذ ذريعة للتجاوز والاستغلال.
ثانياً – توصيف حالة القطاع المصرفي في قطاع غزة في ظل العدوان
بعد توقف القطاع المصرفي وتعطل الصرفات الآلية، وجد المواطنون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى أفراد يقدمون خدمة السحب مقابل عمولة باهضة قد تصل إلى 50%، بدعوى غياب البدائل، وبذلك يمكن فهم أن الدافع الأساسي هو الضرورة حيث لا يتوفر جهات رسمية تقدم خدمة السحب في ظل الظروف المذكورة .
لكن هذه الممارسات، بدل أن تكون وسيلة لتجاوز الضرر تحولت إلى ضرر مضاعف، إذ وصلت نسبة الاقتطاع أي العمولة إلى 50% مما جعلها أقرب إلى الاستغلال المنظم وليس الضرورة.
والأخطر من ذلك، أن بعض التجار سحبوا الأموال من الصرفات لاحتكارها وإعادة بيعها في السوق السوداء، مما ساهم في زيادة تعمق الأزمة.
كان بالإمكان أن يتدخل التجار كحلٍ بديل، بصرف الأموال للناس بدون عمولات مُرهقة، خاصة أنهم لا يتكبدون خسارة حقيقة، ما كان سيخفف من حدة الأزمة وتحقيق التوزان في الأسواق، لكن غياب الرقابة سمح بتحويل الضرورة إلى أداة استغلال.
وعليه فإن مثل هذه التصرفات تخرج عن إطار الضرورة وتدخل دائرة الاستغلال، وتسقط معها أي حماية قانونية يمكن التذرع بها تحت مظلة الظرف الاستثنائي.
ثالثاً – الإطار القانوني المنظم لعمليات الصرف
تنص المادة (6) من قانون سلطة النقد الفلسطينية على أنه “يُحظر على أي شخص أن يباشر أيًّا من الأعمال المصرفية في فلسطين دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد.”
ويستفاد من ذلك أن أي جهة غير مرخصة تقوم بتقديم خدمات مالية أو مصرفية – سواء أكانت فرداً أم كياناً – تعد مخالفة للقانون، حتى في حالات الطوارئ، باعتبار أن التنيظم والرقابة هما الضمانة الأساسية لحماية النظام المالي وحقوق المستفيدين.
فالمشروعية شرطاً جوهرياً لسلامة أي تصرف قانوني، وإذا انعدمت المشروعية أصبح التصرف باطلاً ، أو قابلاً للإبطال، ولا يُعتدّ به قانوناً، كما أن فرض عمولات باهظة في ظروف العدوان يعد انتهاكا لمبادئ العدالة ويشكل استغلالاً واضحاً لحاجة الناس في ظل غياب الحماية المؤسسية.
رابعاً – المسؤولية المدنية: مبدأ “الإثراء بلا سبب”
تنص المادة (200) من القانون المدني الفلسطيني على أن “كل من أثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ولو زال الإثراء لاحقاً” تأتي هذه المادة بقاعدة قانونية عامة مفادها أن تحقيق مكسب مادي على حساب الغير دون سند قانوني، يترتب عليه التزام بالتعويض حتى لو انتهت حالة الإثراء.
وتطبيقاً على الواقع في غزة، فإن قيام أفراد غير مرخصين بموجب قانون سلطة النقد بفرض عمولات تصل إلى 50 % على عمليات سحب الاموال دون تقديم خدمة معينة تبرر هذا المقابل، يجعلهم يحققون إثرا ء غير مشروع على حساب حاجة الناس وظروفهم القاهرة، ويمنح المتضرر حقاً نظرياً في المطالبة بالتعويض بموجب هذه القاعدة.
خامساً – التكيف الجنائي لممارسة سحب الأموال مقابل عمولة
في ضور المادة 311 من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1963، التي تُجرّم إحراز الأموال أو الصكوك أو أي شيء ذي قيمة بطريقة يُشتبه بعدم مشروعيتها، فإنّ ممارسات الأفراد الذين يقومون بتداول الأموال وسحبها مقابل عمولات مرتفعة، دون أن يكونوا مخولين قانوناً بذلك، تُثير شبهة الإحراز غير المشروع.
فقيام هؤلاء الأفراد باحتكار الأموال، ومن ثم إعادة بيعها للمواطنين مقابل نسبة تصل إلى 50%، يجعل الفعل محلّ شبهة جدّية، خاصة في ظل غياب الرقابة، وقد يُدرج تحت طائلة الإحراز غير المشروع للأموال، لما فيه من غموض في مصدر المال وآلية تداوله ومشروعية الاحتفاظ به.
وبالتالي تُشكل هذه الممارسات خرقاً واضحاً لمبدأ التداول المشروع للأموال، وتستوجب حال عودة عمل المؤسسات القضائية التحقيق فيها على ضوء هذه المادة، والمطالبة بإعادة الحقوق لمن وقع عليهم الضرر.
سادساً – حلول قانونية لمواجهة ممارسات السحب غير الرسمية
- تفعيل الرقابة المؤقتة: إنشاء لجنة رقابية مؤقتة تابعة لجهة قانونية (مثل نقابة المحامين أو لجنة أهلية مستقلة) لرصد الممارسات المالية وضبط التجاوزات، ولو بشكل توثيقي لحين عودة عمل المؤسسات الرسمية.
- توثيق التجاوزات تمهيداً للمساءلة: تشجيع المواطنين على جمع الأدلة (صور، تسجيلات، شهود) ضد من يفرض عمولات باهظة دون وجه حق، حتى تُستخدم لاحقاً في دعاوى قضائية عند عودة النظام القضائي.
- سن تشريع استثنائي مؤقت: سن تشريع مؤقت ينظّم عمليات السحب غير الرسمية في ظل تعطل الجهاز المصرفي، على أن يُصدر بمرسوم عن رئيس الدولة بصفته الجهة المختصة أثناء حالة الطوارئ، ويهدف إلى ضبط هذه العمليات، وتحديد سقف العمولة المسموح بها (إن وُجدت ضرورة)، ومنع الاستغلال، وضمان العدالة للمتعاملين. مع التأكيد على أن هذا التشريع يجب أن يكون مؤقتاً ومقيّداً بالظرف الاستثنائي، ويُلغى بزواله.
- إشراك التجار والمؤسسات الأهلية: تشجيع أصحاب المحال والتجار على التعاون مع المواطنين بتوفير سيولة مقابل سلع دون عمولة استغلالية، وتقديم حوافز لهم عبر إعفاءات أو دعم لاحق.
- ضمان الحق في التقاضي لاحقاً: تأكيد أن كل مواطن تضرر مالياً له الحق في إقامة دعوى استرداد أو تعويض عند استقرار الوضع، وفق قواعد “الإثراء بلا سبب” أو “النصب والاحتيال”.
- التوعية القانونية: إطلاق حملات إعلامية قانونية توضح للمواطنين حقوقهم، وتُبيّن أن ما يحدث ليس مقبولاً شرعاً ولا قانوناً، وتشرح كيفية التصرف مؤقتاً لحفظ الحقوق.
بقلم الباحثة: أشجان رائد الشريف
مواضيع أخرى ذات علاقة: